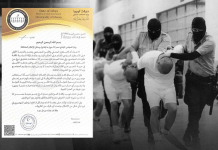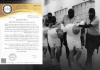كَثُر الجَدل واللَّغط والقولُ على الله بغير علم في زماننا الموحش هذا، وأصبح كلُّ من هبَّ ودبَّ ودرج، يتكلَّم ويفتي في أمور لو عُرضت على ابن القيم لعَرضها على شيخه ابن تيمية.
في كل وادٍ يخوضون بوقاحة وتَعالُمٍ
حُدَثاء أسنان، سفهاء أحلام، بضاعتهم مزجاة في العلم والأخلاق، يتطاولون على القِمم الشمَّاء من العلماء، ويُخطِّئونهم، ويُبدِّعون ويُكفِّرون ويُفسِّقون بلا علم ولا دراية، لا يُفرِّقون بين حمَّالة الحطب وحمَّالة الورد، ولا بين أصلٍ وفرع، لكنَّهم في كل وادٍ يخوضون بوقاحة وتَعالُمٍ.
وقد ازداد الأمر سوءًا بعد انتشار هذه المنتديات والمواقع التواصليَّة على (الإنترنت) التي انتشرت انتشارَ شِعر جريرٍ في الزمن الأموي، فصار القطُّ الرِّعديد – الذي كان يكتم عطستَه في حضرة الأكابر – أشجعَ من عنترة، وأبلغَ من سَحْبان وائل مستعينًا بشيخه؛ مُحرِّك البحث الذي لا يردُّ يدَ لامِس!
أجرَأُ الناس على الفُتيا أقلُّهم علمًا
وقد كان السلف الصالح وغيرهم من علماء الإسلام يمسكون عليهم ألسنتهم إلا لضرورة ليس لهم منها بدٌّ، مع ما لديهم من علمٍ غزير وأدبٍ كثير، قال عنهم شيخ المالكيَّة في عصره سَحْنُون عبدالسلام بن حبيب:
كان بعضُ مَن مضى يريد أن يتكلم بالكلمة، ولو تكلَّم بها لانتفع بها خلقٌ كثير، فيحبسُها، ولا يتكلَّمُ بها؛ مخافةَ المباهاة، وكان إذا أعجبه الصمتُ تكلَّم، ويقول: أجرَأُ الناس على الفُتيا أقلُّهم علمًا[1].
لا يُحدث ضجيجًا إلا الإناءُ الفارغ
وقال عمر بن عبد العزيز: مَن قال لا أدري فقد أحرز نصفَ العلم.
فعلَّق الجاحظ قائلًا: لأن الذي له على نفسه هذه القوة قد دلَّنا على جودة التثبُّت، وكثرةِ الطلب، وقوة الْمُنَّة[2].
ومِصداقُ قولِ الجاحظ ما تقوله العامَّة في أمثالها عندنا في المغرب: (ما تيتقرقرب غير السطل الخاوي)؛ والمعنى: لا يُحدث ضجيجًا إلا الإناءُ الفارغ.
بل هناك مَن عنده علم واطِّلاع على كثير من المسائل وإتقانها، لكنه حين يُسأل في غير فنِّه يستحيي من قول: “لا أدري، ولا أعلم”؛ ظنًّا منه أن ذلك سينقص من قدره وشرفه، وسيجعله صغيرًا أمام أتباعه ومعجبيه؛ فيفتي ويتكلَّم بغير علم، ويأتي بالعجائب، وقد رأينا من هذا الصنف الكثير.
قال ابن الجوزي في (صيد الخاطر): إذا صحَّ قصدُ العالم استراح من كَلَف التكلُّف؛ فإن كثيرًا من العلماء يأنفون من قول: لا أدري؛ فيحفظون بالفتوى جاهَهم عند الناس؛ لئلَّا يُقال: جَهِلوا الجواب، وإن كانوا على غير يقينٍ مما قالوا، وهذا نهاية الخِذلان.
وقد رُوي عن مالك بن أنس: أن رجلًا سأله عن مسألة، فقال: لا أدري، فقال: سافرتُ البلدان إليك، فقال: ارجع إلى بلدِك، وقل: سألتُ مالكًا، فقال: لا أدري.
( لا علم لنا إلا ما علمتنا إنكَ أنت العليم الحكيم )
فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله؛ كيف استراح من الكلفة، وسَلِم عند الله عز وجل؟! اهـ.
وقال عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وأبردُها على الكبد إذا سُئلتُ عمَّا لا أعلم أن أقول: الله أعلم[3].
والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ يرى أن الذي يفتي الناسَ في كل ما يستفتونه مجنون، وهو يقصد العالم الذي عنده آليات وأدوات العلم، فكيف بمن ليس له إلا الجهلُ والغرور، والكِبْر، وسَلاطةُ اللسان وهَذره؟!
ولو سكت مَن لا يعرفُ – كما يقول الغزالي – لقلَّ الاختلاف، ومن قَصَر باعُه، وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه، فما له وللتكلُّمِ فيما لا يدريه، والدخول فيما لا يَعنيه؟! وحقُّ مثل هذا أن يَلزمَ السكوت[4].
وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: 32]: الواجبُ على مَن سُئِل عن علم أن يقولَ – إن لم يَعلم -: الله أعلم، ولا أدري؛ اقتداءً بالملائكة والأنبياء، والفضلاء والعلماء، لكن قد أخبَر الصادق أن بموت العلماء يُقبَض العلم؛ فيبقى الناس يستفتون فيُفتون برأيهم؛ فيَضلُّون ويُضلُّون… قال مالك بن أنس: سمعت ابن هُرْمز يقول: ينبغي للعالم أن يُورِثَ جلساءه من بعدِه: “لا أدري”؛ حتى يكون أصلًا في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري[5].
لقد كان الرجل يُستفتَى فيفتي وهو يرعد
روى يونسُ بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالكَ بن أنسٍ يقول: ما في زمانِنا شيءٌ أقلَّ من الإنصاف.
قلت (القائل القرطبي): هذا في زمن مالكٍ، فكيف في زماننا اليوم الذي عمَّ فينا الفسادُ، وكَثُر فيه الطَّغام؟![6] وطُلب فيه العلم للرياسة لا للدرايةِ، بل للظهورِ في الدنيا، وغَلَبة الأقران بالمِراء والجدال الذي يُقسِّي القلبَ، ويُورِث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى، وترك الخوف من الله تعالى…[7]
قال ربيع: فكيف لو رأوا زماننا هذا الذي نجَم فيه رأسُ الظلم والفتنة، والنفاق والجهل، والكلام على الله بغير علم، وقلة الإنصاف، وهلمَّ شرًّا.
ذكر ابنُ مفلح في الآداب الشرعية أن الإمام مالكًا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامُ المسلمين وسيدُ العالمين – يُسألُ عن الشيء، فلا يُجيبُ حتى يأتيَه الوحي من السماء.
وقال سفيان: لقد كان الرجل يُستفتَى فيفتي وهو يرعد.
(8)وقال: من فتنةِ الرجل إذا كان فقيهًا أن يكون الكلامُ أحبَّ إليه من السكوت
فكيف لو كان هذا المتكلمُ الثَّرثار لا يمتُّ للفقه بصلة، ولا للعلم الشرعي بسبب؟! أكيد سيأتي بجهله على الأخضر واليابس، كما هو مُشاهَد في واقعنا الحاضر.
وصحَّ عن مالك أنه قال: ذلٌّ وإهانةٌ للعلم أن تُجيب كلَّ مَن سألك.
وهو يَقصد رحمه الله بهذا الكلام العلماءَ وطلبةَ العلم الْمُبرَّزين، الذين كانوا ينفقون الليلَ في مُدارَسة العلم، والسفر نهارًا يقطعون الفيافيَ والقِفار من أجل حديث واحد.
لا أدري لا أذكر
وقد أحسن الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد حين استهلَّ مقالته (أتى بالعجائب) بقوله: فالعاقل الذي يُقدِّر نفسه هو مَن لا يتعدَّى حدود ما يعرف، ويتخطَّى إلى ما لا يعرف، حتى لا يكون غرضًا للذمِّ، أو اللوم، أو الإثم[9].
فبالأمس القريب كان زعيم تيار المداخلة يُفتي أتباعه في ليبيا بالقتال جنباً إلى جنب مع مجرمي حفتر سبابي الدِّين والرَّب، نباشي القبور منتهكي الحرمات والأعراض، قاتلي حملة القرآن ، وبصوته مُسجَّلة عليه عند الملائكة الكرام قبل البشر !! قام بإنكارها بعبارة:” لا أدري لا أذكر” ؟!!
هل هو مرض الزهايمر قد أصابه بعد ما سُفِكت دماء الأبرياء المسلمين في ليبيا ! أم الكذب والمراوغة والتنصُّل من المسؤولية في الدنيا قبل الآخرة ؟!!!
ما ذنب من قاتل وسفك الدماء بناءً على تلك الفتوى من زعيمهم قبل أن يتنكَّر لها؟!